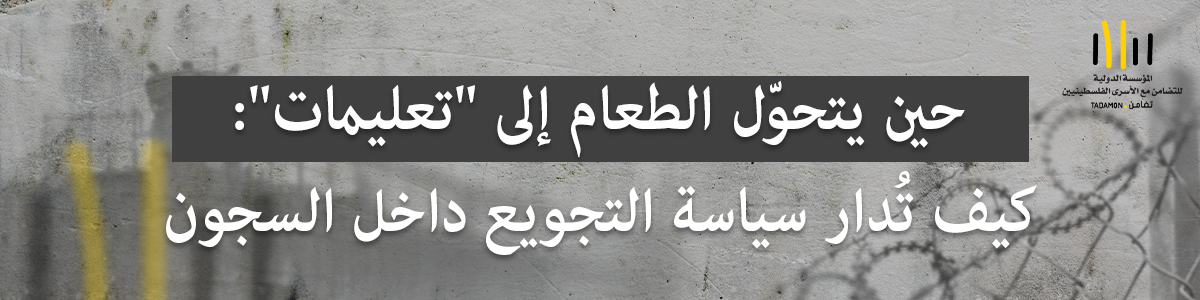حين يتحوّل الطعام إلى “تعليمات”: كيف تُدار سياسة التجويع داخل السجون
لم تعد رواية الجوع داخل السجون الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 قابلة للفهم بوصفها “سوء ظروف” أو نقصًا في الإمدادات. ما يتكشف في شهادات الأسرى وتقاطعها بين سجون ومراكز احتجاز متعددة هو نموذج إدارة: قرار سياسي يُترجم إلى إجراءات، ثم إلى روتين يومي، ثم إلى أثر نفسي وجسدي مُقاس على الأجساد نفسها. الجريمة هنا ليست فقط في تقليص الطعام، بل في طريقة تحويله إلى أداة انضباط: وجبة تُعطى أو تُسحب أو تُؤخر لتنتج الطاعة، وتكسر الاعتراض، وتخلق شعورًا دائمًا بعدم الأمان.
أشد ما يميّز هذا النموذج أنه لا يحتاج إلى عنف ظاهر ليحقق أثره. يكفي أن يصبح توقيت الوجبة مجهولًا، وأن تتحول الكمية إلى “حد أدنى” لا يسد حاجة جسد بالغ، وأن يُغلق باب التعويض تمامًا عبر تقييد الكانتينا ومنع الطهي الذاتي. عندها يُسحب الطعام من كونه حقًا ثابتًا، ويُعاد تعريفه كامتياز قابل للإلغاء. في اللحظة التي يفقد فيها الأسير القدرة على توقع وجبته، يفقد جزءًا من السيطرة على يومه، ثم على توازنه النفسي، ثم على قدرته على المقاومة. ولهذا كان “الانتظار” في شهادات عديدة عقوبة قائمة بذاتها: انتظار وجبة قد تأتي أو لا تأتي، وانتظار تعويض لا يحدث، وانتظار تفسير لا يُقدَّم.
ثم يأتي مستوى أخطر: ربط الطعام بالعقاب الجماعي. الاقتحام لا ينتهي عند التفتيش أو الضرب أو الإهانة، بل تُستكمل حلقته بسحب الوجبة أو تقليصها. هذه ليست مصادفة؛ إنها رسالة سياسية يومية تقول إن الجسد نفسه ساحة انضباط. حين يُعاقَب قسم كامل بسبب “ذريعة” أو احتجاج أو توتر أمني، يصبح الطعام أداة لإعادة تشكيل العلاقات داخل الزنزانة: تتحول الحصة إلى مورد نادر، وتتآكل القدرة على التفكير خارج الحاجة البيولوجية، ويضيق هامش التضامن لصالح حسابات البقاء. ومع ذلك، تظل الشهادات تعكس أن الأسرى فهموا هذا المقصد بدقة: تفكيك الجماعة عبر إدارة الجوع.
الأرقام التي يوردها التقرير عن فقدان الوزن الحاد ليست تفصيلًا طبيًا، بل علامة إدارية على نجاح السياسة في تحقيق غايتها. أن يفقد أسير عشرات الكيلوغرامات خلال أشهر قليلة، وأن تتكرر الأعراض ذاتها في منشآت مختلفة (دوار، رجفة، إغماءات، ضعف توازن، تدهور إدراكي)، فهذا يشي بأن “الخطأ” ليس في مطبخ سجن بعينه، بل في التصميم نفسه: كميات غير كافية، نوعية رديئة، غياب البروتين والفاكهة، وانعدام أي استثناءات للفئات الأضعف. وفي المستوى الذي يتعلق بمرضى السكري والمرضى المزمنين، تتحول المسألة من انتهاك إلى تعريض مباشر للحياة للخطر، لأن اضطراب مواعيد الطعام ليس مجرد قسوة، بل تهديد فسيولوجي يومي.
الأهم أن التقرير لا يكتفي بشهادات فلسطينية، بل يربطها بقرائن داخلية إسرائيلية تعزز صورة المنهجية: مواد وتقارير وإشارات إلى تدقيق رسمي حول الجوع الشديد وتدهور ظروف الاحتجاز. هذا النوع من التقاطع يرفع الوقائع من مستوى “رواية متضرر” إلى مستوى “نمط قابل للإثبات”؛ نمط يعرفه صانع القرار ويواصل اعتماده. عند هذه النقطة تتقدم المسؤولية من نطاق السجّان المنفّذ إلى نطاق السلسلة: خطاب سياسي يمهّد، إدارة سجون تنفّذ وتضبط المعلومات، قادة ميدانيون يطبقون العقوبة، وبيئة رقابية مغلقة بفعل منع الزيارات والقيود على التحقق المستقل.
ولأن التجويع لا يترك كدمات فورية، فقد بدا لكثيرين أقل “ضجيجًا” من الضرب. لكن تأثيره أعمق وأطول: الجوع يغيّر علاقة الإنسان بذاته وبالزمن وبالأمان. بعض الشهادات في التقرير تضيء هذا الأثر بوضوح: ليس ألم المعدة فقط، بل ألم الإهانة، والتبدل النفسي الذي يبقى بعد الإفراج في صورة خوف من نفاد الطعام، أو أكل بطيء، أو شعور دائم بأن المخزون سينتهي. هذه ليست تفاصيل هامشية؛ إنها جزء من أثر التعذيب حين يصبح متكررًا ومنتظمًا وقائمًا على كسر الإحساس بالأمان.
قانونيًا، دلالة هذا التحليل ليست نظرية. عندما يصبح الحرمان من الطعام مقصودًا، وعندما يُستخدم كأداة عقاب وإخضاع، وعندما تُعرف نتائجه ولا تُوقف، فإننا أمام تعذيب ومعاملة قاسية، وانتهاك جسيم لواجبات سلطة الاحتجاز تجاه المحرومين من الحرية. وعندما يتسع النطاق ويتكرر عبر مرافق متعددة ويستهدف جماعة محمية ضمن سياق نزاع واحتلال، فإن الباب يُفتح لتوصيفات أشد: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع ضرورة تدقيق القضاء في عناصر المنهجية والقصد. هذا ما يجعل “التجويع” في هذا التقرير ليس فصلًا إنسانيًا، بل ملفًا قانونيًا قابلًا للاشتغال: لأن الدليل هنا ليس صوتًا واحدًا، بل نمطًا.